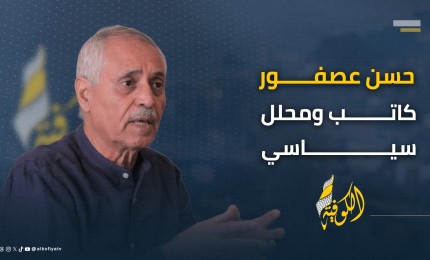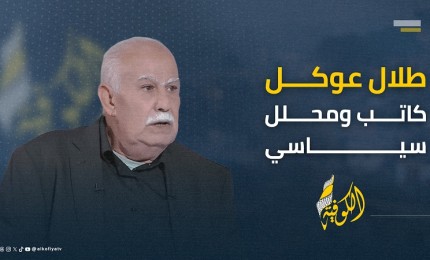السابع من أكتوبر… حين انتصرت الصورة وسقطت الرواية الفلسطينية

بقلم: شريف الهركلي
السابع من أكتوبر… حين انتصرت الصورة وسقطت الرواية الفلسطينية
الكوفية
هوليود المقاومة: كيف بكت الرواية الإسرائيلية العالم ومنحت الاحتلال مفاتيح الجحيم.
منذ السابع من أكتوبر، لم تكن المعركة في الميدان وحده، بل كانت – وربما الأخطر – في الصورة والرواية.
سيناريوهات هوليودية مصوّرة، وثّقتها المقاومة بنفسها، وبُثّت عبر منصّات التواصل الاجتماعي، قبل أن تلتقطها فضائياتٌ جائعة، تتسوّل اللقطة الغريبة والدموية بوصفها “سبقًا صحفيًا”، لتتصدّر بها الترند، وتُرضي شهوة المشاهدة، ولو على حساب الحقيقة والقضية.
لكن السؤال المؤلم الذي لا مفرّ منه يفرض نفسه:
هل كان فعل السابع من أكتوبر يوازي حجم وطبيعة ردّة الفعل الإسرائيلية؟
هل كان “العبقري” الذي خطّط ونفّذ يعلم ما سيأتي بعد الحدث؟
وهل كانت تلك الفيديوهات المصوّرة أثناء التنفيذ تخدم المقاومة والقضية الفلسطينية، أم أنها كانت تصرّفات طائشة لمراهقين سياسيين تحكمهم غريزة الانتقام والتباهي أمام الأضواء، فأسهموا – دون قصد – في سحق الرواية الفلسطينية وتعزيز الرواية الإسرائيلية؟
المشاهد الصادمة من قتلٍ وتمثيلٍ بالجثث بعد الموت لم تكن أخلاق مقاومة.
كانت صورًا أبكت العالم العربي قبل الغربي، ومنحت إسرائيل، بدمٍ بارد، المفتاح الذي فتح أبواب الجحيم على قطاع غزة.
ظهرت المقاومة – أو هكذا صُوِّرت – في صورة الوحش أمام مرأى العالم، بينما جلست إسرائيل على كرسي “الضحية”، تعزف على إيقاع هوليود السابع من أكتوبر، وتقرع طبول حربٍ بلا حدود.
ثم جاءت نشوة الانتصار الكاذب؛ نشوة من شرب الخمر حتى الثمالة، فغاب الصواب الإنساني، وتربّع العناد السياسي على المشهد.
مطالبٌ رُفعت في أول الحرب، قبل أن تبدأ الحرب فعليًا:
لا عودة للأسرى الإسرائيليين إلا بعودة القدس الشريف، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وحلّ كل الملفات العالقة، وتزييت عجلة السلام دفعة واحدة.
انتهت… ولم تنتهِ الحرب الإسرائيلية.
ثم جاءت مطالب أثناء الحرب:
فتح معبر رفح لتسهيل خروج الناس، من مرضى وجرحى، هربًا من قسوة الموت.
إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وأغطية وفراش وخيام.
انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، لتعود المقاومة إلى عقد المهرجانات وبناء الكرفانات، والاحتفال بـ“النصر” فوق الركام، فوق البقع الركامية التي خلّفها الاحتلال.
ثم تأتي مرحلة الإعمار:
إعادة بناء ما دُمّر من بيوت ومؤسسات وبنية تحتية.
ويُغلق بعدها ملف الأسرى الإسرائيليين.
يُتوَّج الفرح الإسرائيلي، ولا نسمع خطابًا سياسيًا واحدًا يطالب بعودة الأسرى الأحياء أو جثامين الشهداء، كأنهم تُركوا على رفوف النسيان، بينما انشغلنا بتفاصيل ثانوية لا تُحرّر أسيرًا ولا تُعيد وطنًا.
إسرائيل، التي لم تقتنع بخطة دونالد ترامب، قبلت بها على مضض، وهي اليوم تضع العراقيل أمام تنفيذ مرحلتها الثانية، وتدق مسمارًا جديدًا في نعش ما يُسمّى بخطط السلام.
ويبقى السؤال الأخطر:
سلاح المقاومة الفلسطينية.
المقاومة تقول إنها لن تتخلّى عنه، ولو مُسحت غزة بأهلها، ولو هُجّر شعبها عن أرضه.
لكن ما فائدة السلاح إذا ضاع المواطن وضاع الوطن؟
وما قيمة البندقية إذا بقيت وحدها، بلا شعب يحميها، وبلا أرض تُقاتل من أجلها؟
أعتذر…
توقفت عن الكتابة.
أصابني دوار، ورأسي ممتلئ بمطارق تدق بلا رحمة.
لم أعد أعرف لمن أكتب.
هل يسمعنا أحد إن كتبنا؟
أم أن العالم قد قرر، منذ السابع من أكتوبر، أن يسمع فقط الرواية التي تُبكيه… ولو كانت كاذبة؟