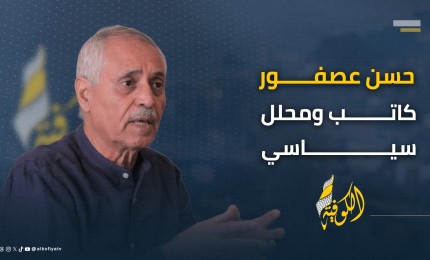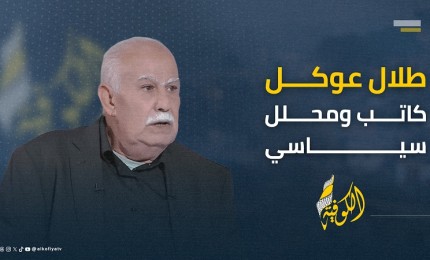معضلة غزة في العقل الإسرائيلي

طلال أبو ركبة
معضلة غزة في العقل الإسرائيلي
الكوفية لم تكن غزة خطأً جغرافيًا في حسابات المشروع الصهيوني، بل كانت منذ اللحظة الأولى فائضًا تاريخيًا خارج السيطرة، عقدةً في العقل التأسيسي للدولة التي أرادت أن تُقام بلا شعب، وعلى أرض بلا ذاكرة... منذ النكبة، فهم بن غوريون أن غزة ليست مجرد شريط ساحلي مكتظ بالبؤس، بل كثافة بشرية فائضة عن قدرة الاستيعاب الصهيوني، فائضًا أخلاقيًا يفضح الأسطورة المؤسسة، ولذلك حاول مبكرًا تقليمها، لا لأنها خطر عسكري، بل لأنها خطر رمزي.
ثم جاء ليفي أشكول، فتوهم أن المعضلة يمكن حلها بإزاحة البشر كما تُزاح الأحجار، فحاول دفع سكان غزة نحو العريش، وكأن الإنسان يمكن اقتلاعه من تاريخه كما تُقتلع اللافتة من الشارع. لكنه اصطدم بحقيقة لم يستوعبها: غزة ليست قابلة للنقل، لأنها ليست مجرد مكان، بل حالة تاريخية متحركة، ومخزنًا للذاكرة الفلسطينية التي فشلت النكبة في محوها.
بيغن حاول أن يذيب غزة في اليومي، أن يحوّلها من قضية إلى مسألة معيشية، ومن صراع إلى إدارة حياة، ففتح الجسور ظنًا منه أن الاقتصاد يمكن أن يهزم الهوية، وأن الرغيف يمكن أن يُسكت التاريخ. لكنه اكتشف أن الجسور ليست دائمًا معابر للاندماج، بل قد تكون مسارات للتمرد، وأن غزة، كلما حاولوا تطبيعها، ازدادت تمرّدًا.
حتى رابين، الذي مثّل العقل الأمني الأكثر براغماتية، انهار أمام هذه المعضلة، ولم يجد سوى أن يتمنى أن يبتلعها البحر... لم يكن ذلك انفعالًا عابرًا، بل اعترافًا صريحًا بعجز القوة حين تواجه شعبًا لا يمكن كسره، وبعجز الدولة حين تصطدم بشعب يرفض أن يتحول إلى هامش.
شارون، الجنرال الذي آمن بالقوة بوصفها لغة السياسة الوحيدة، قرر الانسحاب من غزة، لا بدافع السلام، بل بدافع اليأس. تفكيك المستوطنات لم يكن تنازلًا، بل محاولة للهروب من لعنة المكان. اعتقد أن الخروج منها سيحوّلها إلى عبء داخلي فلسطيني، وأن الصراع سيتآكل داخلها، لكنه لم يدرك أن غزة، حين تُترك وحدها، لا تنطفئ، بل تتحول إلى مختبر للمقاومة، وإلى فضاء يعيد تعريف معنى المواجهة.
ثم جاء نتنياهو، حاملًا مشروعًا أكثر قسوة ووضوحًا: غزة ليست طرفًا في السياسة، بل موضوعًا للعقاب. الحصار لم يكن إجراءً أمنيًا، بل فلسفة حكم، والانقسام لم يكن صدفة فلسطينية، بل سياسة إسرائيلية مُدارة بدقة. غزة تحولت إلى مختبر لإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني: تجويع محسوب، انهيار بطيء، واستنزاف طويل للنفس التاريخي للشعب.
وحين فشلت سياسة الحصار في إخضاع غزة، وفشلت سياسة الانقسام في تفكيكها، اتُّخذ القرار الأخطر: الانتقال من منطق الاحتواء إلى منطق الإلغاء. لم يعد المطلوب السيطرة على غزة، بل اقتلاعها من المعادلة السياسية، بترها من الجغرافيا الوطنية، وتحويلها من قضية تحرر إلى ملف إنساني قابل للتدويل والإدارة الدولية.
هنا لم يعد نتنياهو بحاجة إلى جنرالات فقط، بل إلى جراحين سياسيين. استُدعي ترامب، لا بوصفه رئيسًا أمريكيًا، بل بوصفه مهندسًا لإعادة تشكيل الواقع، رجلًا يؤمن بأن التاريخ يمكن إعادة صياغته بصفقة، وأن الشعوب يمكن دفعها إلى الهجرة عبر إدارة الألم بدل إنهائه. المطلوب لم يكن تدمير غزة فقط، بل إعادة تعريفها: تحويلها من قلب الصراع إلى هامش العالم، ومن قضية سياسية إلى كارثة إنسانية دائمة، ومن شعب يقاوم إلى بشر يبحثون عن منفذ للهروب ....!
في هذه الرؤية، يجب ألا تفكر غزة في المستقبل، وإن فكرت، فعليها أن تراه بعين مكسورة، وبوعي مُنهك، وبأيدٍ مرتجفة أنهكها الحصار، وسلبتها السياسة كرامتها، وأقنعتها القوة بأن البقاء نفسه امتياز مشروط بالطاعة. المطلوب ليس قتل غزة دفعة واحدة، بل قتل قدرتها على الحلم، وإقناعها بأن التاريخ انتهى عند حدود الألم.
لكن المأزق الذي لم يفهمه صناع القرار في تل أبيب، أن غزة ليست مجرد مساحة يمكن بترها، بل هي السؤال الذي لا يمكن التخلص منه. كل محاولة لإلغائها أعادت إنتاجها بشكل أكثر راديكالية، وكل محاولة لإخراجها من الصراع أعادتها إلى مركزه. غزة ليست عبئًا على إسرائيل فقط، بل فضيحة مستمرة لمشروع قام على وهم القوة، وظنّ أن الحديد والنار قادران على إخضاع شعب قرر أن يكون أكبر من الهزيمة.
غزة، في النهاية، ليست مشكلة أمنية، بل مأزق وجودي لدولة قامت على إنكار وجود الآخر. ولذلك، فإن فكرة القضاء على غزة ليست سوى الوجه الأكثر عنفًا لفشل المشروع الصهيوني في الإجابة عن سؤال بسيط: كيف يمكن لدولة أن تعيش فوق أرض لم تنجح في قتل أصحابها؟