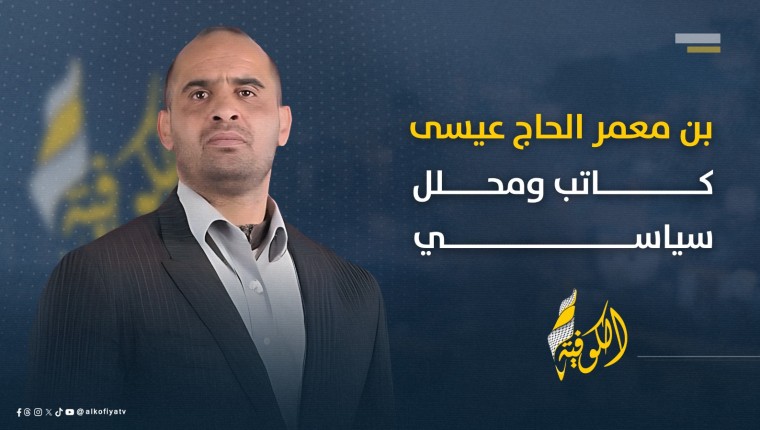في رواية «حكاية.. جناح الفينيق» لـ سماحه حسون في البدء كانت الحكاية رمادًا يتنفس. ومن رحم الركام، تنبثق اللغة في نصّ «حكاية.. جناح الفينيق» ككائنٍ أسطوري يتقن التحوّل من الألم إلى الجمال، ومن الموت إلى الغناء. هذا العمل ليس رواية بالمعنى التقليدي، بل سيمفونية سردية تستعير شكل المسرح والقصيدة والحلم لتعيد تعريف معنى الحكاية الفلسطينية في الوعي الأدبي المعاصر. إنه نصّ ينهض من الحطام لا ليروي، بل ليعيد خلق العالم من خلال اللغة.

منذ المشهد الأول، يفاجئنا الكاتب"سماحه حسون" بتقنية البساطة المتوترة: امرأة تجلس قرب نافذة بيت مهدّم، وطفل ينام بين ذراعيها. غير أن هذا الهدوء الظاهري يخفي عاصفة داخلية من الأسئلة. فالنصّ لا يسرد المأساة، بل يزرعها في اللغة. كل جملة فيه تنبض بتوتر مزدوج بين الرعب والأمل، بين الصرخة والهمس. هنا، اللغة ليست وسيلة للتعبير بل وسيلة للبقاء. الكلمة نفسها تتحول إلى جناح، إلى وسيلة طيران رمزية فوق الخراب.
يعمل الكاتب على تفكيك الحكاية الفلسطينية الكبرى إلى مشاهد متفرقة، كل منها يلتقط ومضة من الضوء في العتمة، ويمنحها شكلًا سرديًا خاصًا. فهو لا يكتب الرواية كزمن متصل، بل كفضاء متشظٍ، كلوحة فسيفسائية من الأصوات والمشاعر والرموز. وهنا يكمن إبداعه الحقيقي: إنه يكتب فلسطين لا كقضية بل كحالة وجودية، كمعنى يتوالد من رماد التجربة الإنسانية، وكأسطورة جماعية لا تخضع لموت الزمان.
من حيث البنية، يقوم النص على وحدة الرموز وتناوب الأصوات. الشخصيات ليست أفرادًا بل أطيافًا للوجدان الفلسطيني: أم يوسف هي الأم الكبرى، رحم الأرض الذي لا يجفّ؛ آدم هو براءة الخلق الأولى التي لم تتلوث بعد بالخذلان؛ ليان هي الوعي الجامعي، الجيل الذي يبحث عن حرية عبر الكلمة لا البندقية؛ الحاج عبد القادر هو الذاكرة التي تفتح الأبواب بالصدأ لا بالمفاتيح. الكاتبة لا تقدّم شخصيات روائية بقدر ما ترسم أيقونات رمزية، لكل منها ظلّ في ضمير النص. لذلك لا يمكن قراءة العمل على مستوى الحدث، بل على مستوى الإيحاء.
كل فصل في الرواية يشبه دورة من حياة الفينيق: احتراق، رماد، ثم بعث. ومع كل دورة تتغير النبرة اللغوية: في البداية تغلب لغة الحزن المجرّدة، ثم تتحول تدريجيًا إلى خطاب جماعي يتقاطع فيه صوت الفرد وصوت الجماعة. هذا التحوّل البنائي ليس مجرد تقنية بل هو جوهر الرؤية: أن الفينيق لا يولد إلا من اشتعالٍ متواصل. وكأن الكاتب يعيد إنتاج الأسطورة في جسد اللغة الفلسطينية المعاصرة، فيجعل من الفينيق استعارة ممتدة للهوية ذاتها، التي تموت وتنهض دون أن تفقد جوهرها.
لغويًا، يعتمد الكاتب على التكرار بوصفه نَفَسًا شعريًا يُؤسس الإيقاع الداخلي للنص. عبارة «العنقاء بدأت رحلتها» تتردد في مواضع متعددة كترتيلة وجودية، تعيد للغة وظيفتها الطقسية. هذا التكرار لا يرهق النص بل يمنحه طاقة دائرية، تذكّرنا ببنية القصيدة الصوفية التي تدور حول مركز غامض هو «الخلود». كذلك تتجاور في النص الجمل المقتضبة المشحونة بالمعنى مع الجمل الوصفية الطويلة، مما يخلق تنويعًا صوتيًا أشبه بالتنفس بين الحزن والرجاء.
تيبدع الكاتب في استخدام الرمز المكاني. فغزة ليست مجرد مكان جغرافي، بل رحم الأسطورة، المدينة التي تلد نفسها من النار. أما الضفة فهي مختبر الكلمة والذاكرة، والقدس هي القلب، مركز النور والمفارقة بين السماء والأرض. هذا التقسيم المكاني الثلاثي يتحول إلى بناء روحي للنص: كل مشهد في مدينة يقابل بعدًا في الوجود - الجسد، العقل، والروح. وحين يتوحد الخطاب في الفصول الأخيرة، تصبح المدن الثلاث جناحين للفينيق نفسه، فيتحقق اكتمال المعنى الرمزي: فلسطين ككائن أسطوري واحد متعدد الملامح، لكنه موحد بالوجع.
من الناحية الأسلوبية، تجمع الرواية بين تقنيات السرد المسرحي والكتابة الشعرية. المشاهد المتتابعة تحمل إيقاعًا بصريًا وحوارات قصيرة مشدودة، كأنها فصول مسرحية مكتوبة بلغة نثرية غنائية. هذا المزج بين السرد والدراما والشعر يجعل النصّ يتجاوز حدود النوع الأدبي. إنه ليس رواية بالمعنى الصارم، بل «أنشودة درامية» عن الوجود الفلسطيني. حتى عندما يصف الكاتب الدمار، يفعل ذلك بوعي جمالي: الركام لا يُروى كخسارة، بل كفضاء تنبت فيه الرموز. وهنا تبلغ اللغة ذروتها، إذ تتحول المأساة إلى مادة فنية، والوجع إلى شكل من أشكال الخلق.
أحد أهم ملامح التفرّد في النص هو تحوّل اللغة من وصف الخارج إلى كشف الداخل. فالرواية لا ترسم مشاهد الحرب بقدر ما تُصغي إلى ما يقوله الصمت بعدها. الأصوات، الهمسات، الخوف، وحتى الغبار، كلها تتكلم بلغة داخلية. أم يوسف لا تبكي على بيتها فقط، بل على ما تبقى من القدرة على الحلم. وآدم، حين يرسم الجدار، لا يمارس فعل الرسم بل فعل المقاومة الجمالية. هنا يصبح الفن نفسه سلاحًا، لا في وجه العدو فحسب، بل في وجه العدم. كل طفل في النص يحمل ريشة أو كلمة أو شتلة، وكلها رموز لأشكال مختلفة من الاستمرار.
الكاتب ينجح أيضًا في بناء شبكة رمزية دقيقة: الشتلة رمز للحياة، الشلال رمز للتطهير، الريشة رمز للخلق، والجناح رمز للتحرر. كل فصل يعيد تأويل هذه الرموز في سياقات جديدة، فتتحول إلى لغة داخلية للنص، كأن الرواية تنسج معجمها الخاص. في الفصول الأخيرة، حين تتسع الدائرة لتشمل الأطفال من أنحاء العالم، يصبح جناح الفينيق عالميًا، ويغدو النص نفسه فعل تواصل إنساني يتجاوز الحدود. وهنا تبلغ الحكاية بعدًا كونيًا: الأسطورة الفلسطينية تتحول إلى ميثولوجيا للإنسان المعاصر، الباحث عن معنى النهوض وسط الرماد.
أما البنية الزمنية، فهي حلزونية لا خطية. لا وجود لبداية أو نهاية، بل تكرار متصاعد لدورة الحياة والموت. الزمان في النصّ يتحرك وفق إيقاع الذاكرة لا التقويم، لذلك يشعر القارئ بأن كل مشهد هو امتداد للذي سبقه وفي الوقت ذاته ولادة جديدة له. هذه التقنية تمنح النص طابعًا صوفيًا، كأن الحكاية لا تُروى لنعرف ما حدث، بل لنتأمل معنى أن يحدث. وتلك هي ذروة النضج السردي: حين يتحول السرد إلى تأمل، والحدث إلى رؤية.
اللغة في الرواية تشبه تنفسًا طويلًا بين جملٍ قصيرة مشحونة بالوجدان وأخرى منسوجة بإيقاع شعري يمتد في الزمن. هناك وعي صوتي في اختيار الكلمات: تكرار حروف النون والميم والراء يمنح النص موسيقى داخلية هادئة تشبه همس الصلاة. والأجمل أن الكاتبة تمارس الاقتصاد في الاستعارة: الصورة لا تأتي للزينة بل للمعنى. عندما تقول مثلًا «الرماد الذي يتنفس»، فهي لا تبحث عن غرابة لغوية، بل تفتح بابًا تأويليًا للكينونة: كيف يمكن للموت أن يظل حيًا؟ كيف يمكن للمكان أن يواصل التنفس بعد الفناء؟ هنا تكمن شعرية النص: في استنطاق المستحيل. من زاوية السرد، تبرز تقنية المرآة السردية بين الشخصيات الثلاث الرئيسة. آدم يرسم، ليان تكتب، والحاج عبد القادر يروي. الرسم، الكتابة، والرواية هي ثلاث مستويات للتعبير عن الذات الفلسطينية: البصر، الفكر، والذاكرة. هذه المستويات تتكامل في المشهد الأخير حين تتوحد الأفعال الثلاثة في جناح واحد: الرسم يصبح كتابة، والكتابة تتحول إلى رواية، والرواية نفسها تصبح جناحًا للحرية. بهذا التوحيد، تبلغ الحكاية معناها النهائي: أن الفن - بكل أشكاله —-هو أداة البعث المستمر.
في منتصف الرواية، يتبدل الإيقاع من الحزن إلى المشاركة الجماعية، حيث تتلاقى المدن الثلاث في شبكة من الرسائل والشتلات. هذا التحول السردي يعكس نضوج الفكرة المركزية: الفينيق لا ينهض من رماده وحده، بل من تعاون الأجنحة. وهنا تظهر البراعة البنيوية في تصعيد المعنى تدريجيًا من الخاص إلى العام، من الأم إلى الجماعة، من الجغرافيا إلى العالم.
أما على مستوى الصورة، فإن الرواية تستعير من الأسطورة لتعيد كتابتها وفق المنظور الفلسطيني. الفينيق هنا ليس الطائر الخرافي الذي يحترق ليولد من جديد فحسب، بل هو استعارة للهوية الجمعية التي ترفض الفناء. في كل مرة ينهار فيها البناء الواقعي، تنهض البنية الرمزية من رماده، لتؤكد أن «الحياة» في المخيلة الفلسطينية لا تُقاس بالزمن بل بالقدرة على الحلم.
تتميّز الرواية كذلك بقدرتها على تحويل الألم إلى جمال دون الوقوع في الابتذال أو العاطفية المفرطة. اللغة تمسك بحافة التوازن بين الإحساس والتجريد، فلا تغرق في البكاء ولا تتجمّد في التنظير. إنّها كتابة تعرف كيف تصرخ بصمت، وكيف تهمس بقوة. والكاتبة تدرك تمامًا أن الجمال في الأدب الفلسطيني لا يُخلق من الزهور، بل من الركام، من الغبار الذي يكتب الشعر بدل أن يمحوه.
ومن أعمق ما يميز النص هو البعد الأنثوي المقاوم: حضور الأم ليس حضورًا بيولوجيًا بل كونيًا. أم يوسف تجسد الأرض – الحاضنة والمُنبتة، صبرها هو المعادل الرمزي للخصوبة رغم الدمار. هذا الحضور الأمومي يعيد إلى الأدب الفلسطيني بعده الإنساني المفتقد في السرديات السياسية، إذ يمنح الصمود ملمسًا حنونًا لا بطوليًا، ويحوّل المقاومة من فعل خارجي إلى فعل حِبٍّ داخلي.
الكاتب أيضًا يستخدم تقنية الانعكاس الرمزي بين المشهد والمشهد: كل صورة تُعاد بصيغة أخرى في الفصول التالية – الجدار، الجناح، المفتاح، الشتلة – كأن النصّ يعيش حالة تناسخ رمزي. هذا التكرار الذكي يمنح الرواية بنيةً موسيقية، تجعلها أقرب إلى قصيدة طويلة منها إلى رواية تقليدية. فالأحداث ليست هدفًا بقدر ما هي نغمٌ متكرر، يذكّر القارئ بأن التاريخ الفلسطيني نفسه ليس خطًا زمنيًا بل لحنًا أبديًا من المقاومة والأمل.
من الناحية الجمالية، تُمارس الرواية اقتصادًا لغويًا راقيًا. كل جملة تبدو محسوبة بإيقاعها الداخلي. حتى الحوارات القصيرة تحمل حمولة رمزية كثيفة. الجمل المقتضبة بين الأطفال أو النساء تُقابلها تأملات طويلة للشخصيات الكبرى، وهذا التباين يخلق توازناً صوتيًا بين البراءة والحكمة، بين الطفولة والذاكرة. وهكذا يتحول النص إلى نسيج متكامل من الأصوات، حيث لا يطغى صوت على آخر، بل تتناغم كلها في سيمفونية واحدة تُعزف على وتر الأمل.
أما على مستوى التلقي، فإن النص يوجّه قارئه نحو قراءة تأويلية مفتوحة. لا شيء يُقال مباشرة، وكل شيء يُلمّح إليه عبر الإيحاء. هذه المسافة الجمالية بين الدال والمدلول تمنح القارئ مساحةً للمشاركة في صناعة المعنى. وهذا ما يجعل «حكاية.. جناح الفينيق» نصًا تفاعليًا لا يُستهلك بالقراءة الأولى. إنه عمل يولّد معانيه باستمرار، كما يولد الفينيق من رماده في كل مرة.
النص ينجح أيضًا في تحقيق مصالحة بين الواقعي والرمزي. فبينما تظل تفاصيل الحرب والركام حاضرة، لا تتحول الرواية إلى وثيقة سياسية، بل تبقى ضمن أفق الفن، حيث الواقع ليس غاية بل مادة أولى لصياغة الجمال. بهذا المعنى، يحقق الكاتب ما لم يحققه كثير من الأدب المقاوم: أن تقول الحقيقة دون أن تقتل الشعر.
في الفصول الأخيرة، حين يمتد جناح الفينيق إلى العالم، تنفتح الرواية على فضاء كوني جديد. لم تعد فلسطين وحدها مركز الحكاية، بل الإنسانية كلها. هذه النقلة من المحلي إلى الكوني لا تُضعف النص بل تعززه، لأنها تنبع من منطق داخلي طبيعي: كل ألم صادق يتحول إلى لغة عالمية. وهكذا، تتحول الرواية من ملحمة وطنية إلى نشيد إنساني شامل، من رمز للنهضة الفلسطينية إلى استعارة عن ميلاد الإنسان في مواجهة الفناء. إن «حكاية.. جناح الفينيق» عمل يتجاوز حدود السرد التقليدي، ليؤسس لمدرسة سردية جديدة يمكن تسميتها بـ «الملحمية الوجدانية الفلسطينية» — كتابة تمزج الحسّ الأسطوري بالوجدان الجمعي، وتعيد إلى الأدب العربي الحديث طاقته الأولى: أن يحكي لا ليوثّق، بل ليحلم، أن ينقذ اللغة من البلاغة الجوفاء، وأن يعيد لها وظيفة البقاء. في نهاية المطاف، يظل الفينيق رمزًا للكتابة نفسها: تحترق الورقة لتولد القصيدة، ويُهدم البيت لتبقى الذاكرة، ويُحاصر الجسد لتتحرر الروح. من هذه المفارقة وُلد النصّ، ومن هذه المفارقة يعيش. إنّ الكاتب لا يكتب عن الفينيق فحسب، بل يكتب بلغة الفينيق — لغة تتغذى من الرماد وتؤمن أن الجمال هو المقاومة الأخيرة.